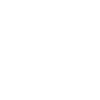التأقلم مع الأمر الواقع

فراس النعسان
حين يكتشف الإنسان أن ما يعيشه ليس ما أراد، يبدأ الجدل القديم بين الانصياع للواقع ومحاولة تغييره. هذه الثنائية لم تفارق التاريخ، ولم تسلم منها حضارة أو فكرة أو كيان. فالتأقلم مع الأمر الواقع يبدو، للوهلة الأولى، نوعاً من البراغماتية، لكنه في عمقه قد يكون أحياناً أشبه باستقالة صامتة من الإرادة، أو استدعاء لفتنة «الممكن» كي يغطي على ضياع «المأمول».
قال هيراقليطس قبل آلاف السنين: «لا يمكنك أن تعبر النهر مرتين، لأن مياهاً جديدة تجري في كل مرة». هذه العبارة قد تُقرأ كإشادة بجوهر التغيّر، لكنها من زاوية أخرى اعتراف بأن الثبات وهم، وأن التأقلم ليس خياراً بل ضرورة. كل من يحاول أن يقف في وجه النهر ينتهي غارقاً، أما من يتعلم السباحة مع تياره فيكتشف سر البقاء.
لكن هل البقاء غاية في ذاته؟ هنا يقف نيتشه على الضفة الأخرى، متأملاً ما أسماه «إرادة القوة»، أي القدرة على إعادة تعريف الواقع لا الانحناء له. فالتأقلم إذا لم يقترن بفعل تغيير، يصبح - وفق هذا المنظور - موتاً بطيئاً للروح، أشبه بالعيش في قوقعة يفرضها الخارج ويقنع الداخل بأنها قدر محتوم.
لطالما تناول الفكر السياسي هذا التساؤل الأزلي: هل ينبغي للإنسان أن ينصاع للواقع كما هو، أم يسعى لتغييره؟ بعض الفلاسفة يرون أن التعايش مع الواقع، حتى وإن كان قاسياً أو جباراً، أشبه بالنجاة من فوضى أعظم، بينما آخرون يعتبرون رفض الواقع والسعي لتعديله واجباً أخلاقياً وسياسياً، طريقاً لإعادة بناء العدالة والكرامة. التاريخ في جوهره دوّامة بين الاستسلام الحكيم للممكن، والمغامرة الجريئة للسعي وراء المثالي، بين القبول كخيار واقعي، والرفض كخطوة نحو الأمل.
في زمننا الراهن، صار «التأقلم» مفهوماً متعدد الوجوه. أحياناً يلبس ثوب الواقعية السياسية، وأحياناً يُقدَّم كفنّ البقاء في عالم يتغير بسرعة، وأحياناً أخرى يتحوّل إلى أيديولوجيا تبريرية تُخدّر العقل الجمعي. هنا يحضر جان بودريار الذي رأى أن العيش داخل «المحاكاة» قد يجعلنا نتوهم أن ما نقبله هو الواقع ذاته، بينما هو في الحقيقة نسخة مصطنعة منه. التأقلم مع نسخة الواقع ليس تأقلماً بل انخداعاً بالصورة.
ولعل أخطر ما في الأمر أن التأقلم يملك قدرة مزدوجة: فهو ينقذ الأفراد والجماعات من الانكسار الفوري، لكنه في الوقت ذاته قد يُبقيهم أسرى واقع لم يصنعوه، كمن يختبئ من العاصفة في كهف، لكنه يكتشف لاحقاً أن الكهف صار سجناً.
هيدغر تحدث عن «الوجود في العالم» باعتباره اختباراً دائماً بين الأصالة والاغتراب. من يتأقلم بلا وعي يغترب، ومن يرفض مطلقاً يغرق في العدمية. لذا، ربما تكون الحكمة في ما سمّاه أرسطو «الوسط الذهبي»: أن نعرف كيف نعيش مع الواقع، من دون أن نفقد الحق في نقده وتغييره.
إنّ أعظم إغراءات التأقلم أنه يريح من مواجهة المجهول. الإنسان يخشى الفوضى أكثر مما يخشى الظلم، ويخشى الغموض أكثر مما يخشى الجمود. لذلك يفضّل كثيرون أن يعيشوا في واقع ناقص، بدلاً من المخاطرة بواقع جديد لا يملكون ضماناته. لكن التاريخ يخبرنا أن الأمم التي استسلمت لهذا المنطق خسرت أكثر مما ربحت، وأن التغيير لم يولد يوماً من حضن القبول، بل من رحم المغامرة.
في النهاية، لا يمكن إدانة التأقلم كلياً، ولا تمجيده مطلقاً. إنه أشبه بسيف ذي حدين: يمكن أن يكون حكمة واقعية حين يحمي الوجود من الانكسار، ويمكن أن يكون خيانة حين يتحول إلى استسلام دائم. المعادلة الدقيقة تكمن في وعي لحظة التوازن: متى يكون التأقلم جسراً نحو المستقبل، ومتى يصبح قيداً يرسّخ الماضي؟
ربما نعود إلى مقولة قديمة للفيلسوف الرواقي سينيكا: «ليست الرياح ما يقرر وجهتنا، بل اتجاه الشراع». الرياح هي الواقع، والشراع هو الإرادة. من يعرف كيف يعدّل شراعه لا ينهزم أمام العاصفة، لكنه أيضاً لا يذوب في تيارها.
إن أعقد معركة في الفكر والسياسة ليست بين الحرية والعبودية فقط، بل بين التأقلم كفنّ للبقاء، والتغيير كفنّ للوجود. وما بينهما، يتشكل قدر الأفراد كما تتشكل مصائر الأمم.
من صحيفة الدستور الأردنية